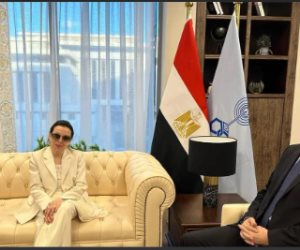سقط الوهم وبقي الوطن.. من المودودي إلى قطب.. "الحاكمية" سلاح الإخوان الإرهابية لتكفير المسلمين
السبت، 11 أكتوبر 2025 10:54 م
الجماعة حوّلت «الحاكمية» من مبدأ ديني إلى ذريعة فوضوية تُبرّر العنف وتمنح الغطاء الشرعي للإرهابيين
الصدام مع المجتمع والتمرد على الدولة وغلق باب السياسة باسم الله "فريضة إخوانية" لاحتكار الإيمان والسلطة معًا
الروايات والكتب الإخوانية انتجت تنظيم مشوَّه الوجدان يرى في الجيش عدوًا وفي العلم رمزًا للطاغوت وفي التضحية لأجل الأرض خروجًا على العقيدة
لم يكن صعود جماعات الإسلام السياسي إلى الحكم بعد عام 2011 انتصارًا فكريًا كما روّجت أدبياتها، ولا «عودة الروح» للإسلام كما صوّر أنصارها؛ بل كان تجليًا متأخرًا لأزمة فكرية عمرها قرن، وصلت إلى ذروتها حين تحولت فكرة «حاكمية الله» إلى غطاء أيديولوجي للسلطة والتنظيم.
فما بدا لحظة تمكين ديني كان في جوهره اختبارًا قاسيًا لعقيدة وُلدت من رحم الصدام مع الحداثة، واصطدمت حين وصلت إلى الحكم بواقع الدولة ومؤسساتها، لتكشف هشاشة البناء النظري الذي طالما تغنّت به، وكما صعدت تلك الجماعات على أكتاف الموجة الشعبية، سقطت تحت ثقل خطابها نفسه، بعدما فشلت في تحويل الشعارات إلى نظام حكم واقعي.
لقد أفرزت تجربة الإسلام السياسي، في لحظتها التاريخية تلك، سؤالًا أكثر جذرية من مسألة الأداء أو الإدارة: هل انهزمت الجماعات الإسلامية لأنها لم تُحسن إدارة الدولة؟ أم لأنها حملت في داخلها بذور الفشل منذ لحظة التأسيس الفكري؟
أحد المفاتيح التي تُجيب عن هذا السؤال هو مفهوم «الحاكمية» الذي صاغه كلٌّ من أبو الأعلى المودودي وسيد قطب في منتصف القرن العشرين، كجوهر لتوحيد السيادة في الإسلام؛ لكن الواقع أثبت أن هذه الفكرة، التي رُفعت شعارًا دينيًا، لم تُنتج «نظامًا إسلاميًا» بقدر ما أنتجت هندسة مغلقة للسلطة، تُقدّس التنظيم وتكفّر المجتمع، وتُقدّم «المرشد» باعتباره ظلّ الله في الأرض.
فـ«الحاكمية» التي وُلدت كصيغة لتأكيد مرجعية النص، تحولت في الممارسة إلى ذريعة لاحتكار تفسير النص، ومن ثمّ احتكار الحكم باسمه، ولم تكن دعوة لتطبيق الشريعة بقدر ما كانت آلية لإعادة إنتاج الطاعة داخل الجماعة، حيث تُختزل إرادة الله في قرار القيادة، وتُختصر الأمة في الصف التنظيمي، وبهذا المعنى، كان مشروع الحاكمية أقرب إلى تقديس الحزب باسم الدين منه إلى إقامة دولة تُجسّد روح الإسلام.
وحين اصطدمت الجماعات الإسلامية بالدولة الحديثة، وجدت نفسها أمام مأزق وجودي مزدوج: فهي من جهة ترفع شعار «الحكم بما أنزل الله»، ومن جهة أخرى تضطر إلى استخدام أدوات الدولة المدنية التي كانت تُكفّرها بالأمس، وهو تناقش كشف ضعف الكفاءة السياسية، وانهيار الفكرة نفسها، لأنها لم تستطع التوفيق بين العقيدة والتنظيم، بين المثال الإلهي ومتطلبات الدولة، بين الخطاب الدعوي ومقتضيات الحكم.
من المودودي إلى قطب.. فكرة متطرفة من رحم الصدام
لم تولد «الحاكمية» كفكرة بريئة في سياق ديني محض، بل نشأت من رحم الصدام التاريخي بين الإسلام السياسي الناشئ والحداثة الغربية الزاحفة، كانت النواة الأولى في فكر "أبو الأعلى المودودي" (1903–1979)، الذي صاغها في بيئة هندية مستعمَرة تعيش ارتباك الهوية بين الإسلام التقليدي والدولة الحديثة.
وأراد المودودي أن يقدّم مشروعًا مضادًا للعلمانية البريطانية، فابتدع مفهوم «الحاكمية لله وحده» بوصفه ردًّا عقائديًا على سلطة البشر؛ لكنه في الحقيقة لم يكن يؤسس لفكر إصلاحي، بل لعقيدة "تكفيرية مضمَرة" تُسقط شرعية أي حكم مدني أو وطني لا يرفع شعار "شريعة الله".
فقد عرّف المودودي الحاكمية بأنها «السلطة العليا والمطلقة التي يُسنّ بها القانون بإرادة صاحبها»، ثم بنى عليها تصوّرًا يجعل من رفض «الجاهلية الحديثة» واجبًا دينيًا، وبهذا فتح الباب أمام أول نسق فكري يُضفي «القداسة على السياسة»، ويحوّل الدولة من فضاء مدني إلى ميدان تعبدي، يُقسَّم الناس فيه بين «أنصار الله» و«أتباع الجاهلية».
وانتقل هذا البناء النظري لاحقًا إلى مصر على يد «سيد قطب» (1906–1966)، الذي التقط الفكرة وأضاف إليها بعدًا ثوريًا حادًا، فبعد سجنه في الخمسينيات، أعاد قطب تعريف الحاكمية لا كتصور فقهي، بل كـ «بيان حرب وجودية» بين «حاكمية الله» و«حاكمية البشر».
وظهر ذلك في مؤلفات قطب، ففي كتاباته المتأخرة، ولا سيما «معالم في الطريق»، أعلن أن «وجود هذا الدين هو وجود حاكمية الله، فإذا انتفى هذا الأصل انتفى وجود هذا الدين».. وهنا يتحوّل الإيمان إلى ولاء سياسي، وتصبح المجتمعات التي لا تحكم بالشريعة مجتمعات «جاهلية» تُستباح مقاومتها باسم «التوحيد».
وبكلمات أخرى، حوّل قطب الفكر المودودي من نقدٍ للغرب إلى «مشروع لتكفير الداخل» فصار كل نظام وطني أو حكم مدني امتدادًا للطاغوت، وبهذا التوصيف الخطير، نقل الحاكمية من حيز الفكرة إلى «أداة أيديولوجية للعنف»، تبرر الصدام مع الدولة وتمنح الغطاء الشرعي للجماعات الراديكالية التي ظهرت لاحقًا.
ولم تكن هذه الانعطافة الفكرية مجرد تطور في الاجتهاد الديني، بل كانت انقلابًا على تراث الإسلام السياسي نفسه؛ إذ تمركزت الفكرة حول «السلطة المطلقة الإلهية» لا «المصلحة العامة»، فتحولت إلى أيديولوجيا مغلقة ترى في أي صيغة مدنية تهديدًا للعقيدة، ولذلك مثّلت الحاكمية عند قطب «الخط الفاصل بين الإيمان والكفر، وبين المجتمع المسلم والمجتمع المرتد»، ما جعلها المرجعية العقائدية لكل التيارات التكفيرية من بعده.
وتجاوز أثر هذه النظرية نطاق الفكر إلى ساحة الحركات السياسية، فحين تبنّت جماعة الإخوان الإرهابية فكرة «الحاكمية» ضمن خطابتها، تحولت من نصّ تنظيري إلى «أداة شرعنة» للصراع على السلطة.
وهنا لم تعد المسألة دعوة إلى الإصلاح أو الشورى، بل إلى «استرداد الحكم من أيدي البشر»، أي من مؤسسات الدولة الوطنية نفسها، وهكذا تسرّبت روح التكفير إلى بنية الإسلام السياسي الحديثة تحت غطاء الدفاع عن «التوحيد السياسي».
لقد كانت هذه الفكرة -في جوهرها - «تسييسًا للتوحيد وتكفيرًا للمجتمع»، لا إصلاحًا دينيًا كما زُعِم، وهي ما أسس لاحقًا لكل خطاب يتذرع بالدين لهدم الدولة، من فكر التنظيم الخاص إلى تنظيرات داعش والقاعدة، فالحاكمية، في حقيقتها، لم تكن نداءً للإيمان، بل مشروعًا لإلغاء الآخر وتحويل الإيمان إلى سلطة مطلقة تحكم ولا تُسأل.
من الشعار إلى الكارثة.. مأزق التطبيق في مصر وتونس
لم يكن وصول الإخوان إلى الحكم في مصر عام 2012 تحقيقًا لـ«خلافة راشدة» كما صوّرت جماعة الإخوان الإرهابية، بل كان بداية انكشاف عملي لوهم الحاكمية حين نُزِّلت من صفحات الكتب إلى دهاليز الدولة.
ومنذ اللحظة الأولى، تعاملت الجماعة مع السلطة بوصفها «تكليفًا إلهيًا» لا تفويضًا شعبيًا، فحوّلت صندوق الاقتراع إلى منبر دعوي، والدستور إلى وثيقة بيعة باسم الله، وهو ما تجسد في عدد من المواقع، فالجماعة الإرهابية رفعت شعارات الشرعية و«تطبيق شرع الله»، لكنها لم تكن سوى غطاء سياسي لاحتكار القرار، إذ جرى استبدال مفردات السياسة بلغة التكفير والإقصاء.
فخطابات رئيس الجماعة الراحل محمد مرسي لم تعبّر عن مشروع وطني، بل عن عقيدة تفوّق عقدي تُقصي كل مخالف وتصفه بالعداء للدين، وعندما تصاعد الصدام مع القضاء والمعارضة، لم تتورع الجماعة عن استخدام «حاكمية الله» كسيف في وجه الدولة، لتبرير تغوّلها وتحصين قراراتها من أي رقابة.
لكن سرعان ما انهارت التجربة أمام الواقع، فالإخوان الذين وعدوا بحكم «الشريعة» وروجت له في مشروع «النهضة» لم يتنج في إدارة الدولة ولا في بناء توافق وطني، لأنها ببساطة لم تعترف بالدولة إلا كوسيلة، وحين واجهت الرفض الشعبي، عادوا إلى قاموسهم القديم، ووصموا خصومهم بـ«الجاهلية»، في مشهد يعكس عمق الأزمة الفكرية لا مجرد فشل سياسي.
لقد تحوّلت «الحاكمية» من مبدأ ديني إلى ذريعة فوضوية تُبرّر العنف والتمرد على الدولة المدنية، وتغلق باب السياسة باسم الله، لذا كانت التجربة المصرية الاختبار الأكثر قسوة للحاكمية، إذ كشفت أن الفكرة في أصلها لا تحتمل التعدد ولا تؤمن بالمواطنة.
فحين تصبح «المرجعية الدينية» كيانًا فوق الدولة، تتحول الديمقراطية إلى خطيئة، والمعارضة إلى كفر، والحاكم إلى ظل إلهي منزّه عن النقد، لذلك، لم يسقط الإخوان لأن خصومهم تآمروا عليهم، بل لأنهم أسقطوا الدولة باسم الله، فسقطوا تحت ثقل أوهامهم.
ولم يكن فشل الإخوان في مصر حدثًا معزولًا، بل كشف عن مأزق بنيوي في فكر الحاكمية ذاته؛ فالفكرة منذ نشأتها قامت على نفي الإرادة البشرية وتكفير المجال السياسي الحديث، ما جعلها بطبيعتها على تضاد مع مفهوم الدولة الوطنية ومؤسساتها، فكل ما لا يخضع لتأويل الجماعة يُعَدُّ خروجًا عن «الشرع»، وكل سلطة خارج التنظيم تُصوَّر كاغتصاب لحق الله في الحكم.
ومن هنا، لم يكن الصدام مع المجتمع خيارًا سياسيًا، بل نتيجة حتمية لمنظومة فكرية ترى في نفسها «الفرقة الناجية» وفي الآخرين «معسكر الكفر»، وبذلك تحوّل مبدأ الحاكمية من شعار ديني إلى أداة استبداد ديني تسعى لاحتكار الإيمان والسلطة معًا، وتُقصي الدولة والمجتمع تحت دعوى إقامة الدين.
وفي تونس، كانت تجربة (حزب النهضة)، حيث سلكت الجماعة الإرهابية مسارًا يبدو أكثر براغماتية، لكنه لم يخلُ من تناقضات عميقة، فالحركة التي رفعت شعار «الحكم لله» في خطاباتها الأولى، وجدت نفسها في مواجهة واقع سياسي لا يعترف بالشعارات العقدية، فاختارت المهادنة حفاظًا على البقاء، ومع حكومة "الترويكا" (2011–2014)، دخل حزب النهضة في تسويات اضطرارية أنتجت دستورًا مدنيًا، لكنها دفعت ثمنًا باهظًا: التنازل عن مشروع الحاكمية مقابل البقاء في المشهد.
وخرج راشد الغنوشي - الذي كان يومًا يبرّر الحاكمية بوصفها جوهر الإسلام السياسي - لاحقًا ليقول إن التنازلات لصالح الديمقراطية واجبة من أجل إنقاذ تونس، وهو اعتراف لم يكن بطولة فكرية، بل انكسارًا أيديولوجيًا صريحًا أمام صلابة الدولة الوطنية.
ففي أكتوبر 2013، تنازلت النهضة عن رئاسة الحكومة والبرلمان طوعًا، في لحظة مثّلت عمليًا دفنًا لفكرة الحاكمية على يد أصحابها، ومع تصاعد أزمات الحكم، بدأ الغنوشي يخفّف لهجته من "الحاكمية المطلقة" إلى التوافق الوطني، متحدثًا عن «رصّ الصفوف بين مؤسسات الحكم» كبديل عن الحكم الأحادي، وهو هنا اضطر إلى مغادرة قاموس «الطاعة لله» إلى مفردات الدولة المدنية، مدركًا أن لغة الحاكمية لا تصنع استقرارًا ولا تجلب شرعية في دولة حديثة.
يرى مراقبون أن هذا التحوّل لم يكن نابعًا من مراجعة فكرية حقيقية، بل من عجزٍ سياسي عن تطبيق الشعار؛ فالحركة التي بشّرت بحكم الإسلام وجدت نفسها تُدافع عن الديمقراطية الغربية التي كانت تكفّرها بالأمس، ومع الوقت، تآكل خطاب «الحاكمية» داخل النهضة حتى أصبح عبئًا على صورتها، ليتراجع أمام شعارات «الوطن» و«الدولة المدنية».
وهنا أثبتت التجربتين المصرية والتونسية أن «الحاكمية» ليست طريقًا إلى النهضة، بل عقيدة استبدادية متنكرة في ثوب ديني، سقطت في مصر لأنها اصطدمت بالمجتمع، وفي تونس تآكلت لأنها انهارت أمام الدولة، والنتيجة واحدة: كلما اقتربت جماعات الإسلام السياسي من الحكم، انكشف عجزها عن التوفيق بين شرعية السماء والأرض، وبين الشعارات والواقع، بين الخطاب الإلهي والدولة - من وجهة نظرهم -.
الحاكمية والوطن.. تفنيد رسمي للفكر الإخواني
لم تكن معركة «الحاكمية» التي رفعها الإخوان يومًا مع الله، بل مع الوطن نفسه؛ فحين جعلت الجماعة ولاءها للعقيدة قبل الأرض، حوّلت الإسلام من دينٍ للعمران إلى أيديولوجيا عابرة للحدود، لا ترى في الأوطان إلا جغرافيا مؤقتة تُدار لمصلحة التنظيم.
ومن هنا، لم يكن غريبًا أن تُختزل مصر في أدبيات سيد قطب بـ«حفنة تراب لا قيمة لها»، وأن يتحول الانتماء الوطني إلى بدعةٍ، وحب الوطن إلى انحرافٍ عن التوحيد؛ لكن الدولة المصرية، التي دفعت ثمنًا باهظًا لمغامرات هذا الفكر، لم تكتفِ بالمواجهة الأمنية، بل قررت تفكيك الأساس الفكري لتلك الدعوى على نحوٍ منهجيٍّ وشرعيٍّ، لتعيد للوطن مكانته في وجدان الدين ذاته.
وفي هذا السياق، قدّمت وزارة الأوقاف رؤية فكرية حاسمة تُعيد تعريف العلاقة بين الإسلام والوطن، مؤكدة أن حب الوطن ليس انحرافًا ولا خروجًا عن التوحيد، بل هو من صميم الفطرة الإنسانية التي أقرها الشرع.
يقول الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن «سيد قطب خالف الفطرة السليمة وفهم علماء الأمة» حين اختزل الوطن في الأرض، نافيًا عنه البعد الروحي والإنساني الذي يربط الإنسان بأرضه وشعبه وتاريخه. وبهذا الموقف، لم يكن الأزهرى يدافع عن وطنٍ فقط، بل عن مفهوم الدين ذاته، ضد من أرادوا أن يجعلوا الله ضد الإنسان، والدين ضد الدولة.
فالفكر القطبي الذي صاغ لبنة الحاكمية الإخوانية الأولى، قام على قاعدة نفي الانتماء الوطني، واستبدال الولاء للوطن بولاءٍ للتنظيم؛ فالوطن في هذا الفهم ليس سوى «دار إقامة مؤقتة»، لا قداسة لها ولا واجب تجاهها، بل تصبح «دار كفر» إذا لم تخضع لتصوراتهم للحكم.
وأنتجت هذه الرؤية جيلًا مشوَّه الوجدان، يرى في الجيش عدوًا، وفي العلم الوطني رمزًا للطاغوت، وفي التضحية لأجل الأرض خروجًا على العقيدة، وهنا جاءت أهمية الرد الرسمي، الذي لم يكتفِ بإدانة التطرف بل فكك منطقه الداخلي، مبيّنًا أن الإسلام ذاته هو من أسّس لمعنى الوطن وأسبغ عليه قداسته.
لقد أعادت وزارة الأوقاف في قراءتها الجديدة خلال أكتوبر 2025، قراءة النصوص الشرعية في سياقها الصحيح، لتؤكد أن حب الوطن ليس بدعة، بل فطرة أصيلة أقرها القرآن والسنة. فالنبى صلى الله عليه وسلم بكى وهو يودع مكة قائلًا: «والله إنكِ لأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أُخرجت منكِ ما خرجت»، في إشارة صريحة إلى أن الانتماء للأرض جزء من العقيدة وليس خصمًا منها؛ بل إن علماء الأمة، من الرازى إلى ابن حجر، أجمعوا على أن مفارقة الأوطان عقوبة عظيمة، وأن الحنين إليها أمر فطرى مشروع، ومن ثمّ فإن من ينزع من الإنسان حبه لوطنه، إنما ينزع منه إنسانيته قبل إيمانه.
ومن هنا تتجلى المفارقة بين «مفهوم الوطن عند المتطرفين» و«مفهوم الوطن في الشرعية»، فالإخوان يرونه حفنة تراب، بينما يراه الإسلام منظومة قيم وذكريات وشعب وتاريخ، أي كيانًا جامعًا للروح والمكان معًا.
أما من زاوية الفقه المقاصدي، فإن الشريعة جاءت لحفظ الضروريات الخمس، ومنها «النفس» و«المال» و«الدين»، ولا يتحقق حفظها إلا في إطار دولةٍ مستقرةٍ ووطنٍ آمنٍ، فكيف يمكن أن تُعمر الأرض، كما يأمر الله في قوله تعالى: {هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها}، إذا كان الفكر القطبي يُحرّم أصلاً الاعتراف بها؟!
لقد حرصت وزارة الأوقاف في هذا السياق على إظهار التناقض البنيوي بين دعوى الإخوان ومقاصد الشريعة، فبينما تزعم الجماعة أن حب الوطن نوع من العصبية الجاهلية، تُثبت النصوص أن العمل لأجله من أعظم القربات، لأنه يحقق مقصد «عمارة الأرض».
وحين ترفض الجماعة الانتماء الوطني وتُحرّم العمل في مؤسسات الدولة، فإنها بذلك تخالف إجماع العلماء الذين أقروا أن خدمة الوطن واجب شرعي، وأن الدفاع عنه جهاد في سبيل الله؛ ولذا، فإن التيار القطبي لا يكتفي بتجريد المسلم من هويته الوطنية، بل يدفعه إلى عزلةٍ فكريةٍ قاتلة تجعله غريبًا في أرضه، عدواً لمجتمعه.
وعلى الجانب الآخر، قدّمت رؤية الأوقاف توازناً دقيقًا بين الانتماءين: الديني والوطني، فهي لا تفصل بين حب الدين وحب الوطن، بل تعتبر الثاني امتدادًا للأول، لأن الوطن هو الإطار الذي تُقام فيه الشعائر وتُحفظ فيه القيم.
فالولاء للوطن، بحسب هذه الرؤية، ليس ولاءً ترابيًا أجوف، بل التزامًا بالعمل والإصلاح والعدل والإحسان، وهنا يبرز البعد الإصلاحي للفكر الديني الرسمي في مصر، الذي يسعى إلى تأصيل مفهوم «المواطنة المسؤولة» باعتبارها جسرًا بين الانتماءين، لا خصمًا بينهما، وهي رؤية تتسق مع منطق الدولة الوطنية الحديثة التي تقوم على عقدٍ اجتماعيٍ جامع، لا على بيعةٍ أيديولوجيةٍ ضيقة.
ويؤكد الأزهري في طرحه أن الموازنة بين الانتماءين لا تعني خلط الدين بالسياسة، بل تعني إدراك تكامل الأدوار: فالإسلام دين يهذّب الضمير، والدولة وطن يحمي الكيان، ومن هذا الفهم، يصبح الدفاع عن الوطن دفاعًا عن الدين، لأنه يحمي الأرض التي تُقام عليها عبادات الله، ويحفظ المجتمع من الفوضى التي يريدها دعاة الحاكمية. وهنا تتضح المفارقة الكبرى بين الإسلام كدينٍ للحياة، وفكر الإخوان كعقيدةٍ للموت.
ولأن المواجهة الفكرية هي أعمق من مجرد الردود، فقد حرصت وزارة الأوقاف على تقديم تفنيد شامل للنتائج الكارثية لفكر «حفنة التراب»، مبينة أن إنكار الوطن يقود إلى إنكار الدولة، وإنكار الدولة يقود إلى انهيار الشريعة نفسها، لأن الشريعة لا تُقام إلا بسلطانٍ يحفظها، فالمتطرف الذي يرفض الانتماء الوطني ويعتبر مؤسسات الدولة «كافرة»، لا يدرك أنه بذلك يهدم الإطار الذى يحمي دينه، ويحوّل المجتمع إلى غابةٍ من الفوضى. وهكذا، يتحول فكر الحاكمية إلى مشروع لتدمير الدولة باسم الله، بينما يقدّم الإسلام الحقيقي مشروعًا لبناء الدولة باسم الإنسان.
وبهذا، يصبح خطاب الدولة المصرية ضد الحاكمية ليس ردًا وعظيًا، بل مشروعًا فكريًا لإعادة التوازن بين الدين والسياسة، بين الفطرة والنص، بين الوطن والعقيدة، ففي مواجهة من قالوا إن «الحكم لله» بمعنى احتكار التفسير والسلطة، تقول الدولة إن «الحكم لله» بمعنى إقامة العدل وصيانة الحياة، وهو المعنى الذى يترجمه حب الوطن في أبسط صوره: العمل، التضحية، والانتماء. وبين هذين الفهمين يتضح الفرق بين من يتعبد لله بالهدم، ومن يعبده بالبناء.
وهكذا تُغلق وزارة الأوقاف دائرة الجدل حول «الوطن في الإسلام»، مؤكدة أن الدفاع عن الدولة الوطنية ليس موقفًا سياسيًا فحسب، بل واجب ديني أصيل، فالإسلام، الذي بدأ برسالة في مكة وبُعث في وطنٍ محددٍ وزمانٍ معلوم، لا يمكن أن يُختزل في شعاراتٍ جوفاء تلعن الأوطان وتقدّس الفوضى، وبالتالي إن حب الوطن، ليس حفنة تراب، بل عقيدة حياة، وفطرة إنسان، وواجب شرع، وهو ما أدركه المصريون حين حملوا رايات أكتوبر، وحين واجهوا إرهاب الجماعة بالوعي لا بالسلاح فقط. ومن هنا، فإن معركة الحاكمية انتهت إلى نتيجتها الحتمية: سقط الوهم، وبقي الوطن.